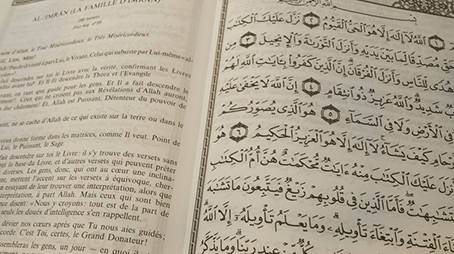
جذب القرآن الكريم بطريقته المثلى في عرض عقيدة الإسلام وشريعته، وبأسلوبه المتفرد في صياغة أفكاره ومبادئه، اهتمام كثير من الأوروبيين، فدعوا إلى ترجمته أولاً قبل دراسته بعد ذلك، وكانت أول ترجمة للقرآن الكريم باللغات الأوروبية باللاتينية، وقد تمت -كما يقول محمد صالح البنداق- بإيعاز وإشراف رئيس دير (كلوني) في جنوب فرنسا الراهب بطرس المبجل، وكان ذلك سنة (1143م) وعلى يد راهب إنجليزي يدعى روبرت الرتيني، وراهب ألماني يدعى هرمان الدلماطي.
والمثير للاستغراب، أن الدوائر الكنسية منعت طبع هذه الترجمة وإخراجها إلى الوجود؛ لأن إخراجها من شأنه أن يساعد على انتشار الإسلام، بدلاً من أن يخدم الهدف الذي سعت إليه الكنيسة أصلاً، وهو محاربة الإسلام.
وظلت هذه الترجمة مخطوطة في نسخ عدة، تتداول في الأديرة مدة أربعة قرون فقط إلى أن قام ثيودور بيبلياندر بطبعها سنة (1543م) وسميت هذه الترجمة ترجمة بيبلياندر، وتميزت بمقدمة لـ مارتن لوثر، وفيليب ميلانختون. وقد تحدث عن هذه الترجمة جورج سال قائلاً: "إن ما نشره بيبلياندر في اللاتينية زاعماً بأنها ترجمة للقرآن الكريم لا تستحق اسم ترجمة؛ فالأخطاء اللانهائية، والحذف، والإضافة، والتصرف بحرية كبيرة في مواضع عدة يصعب حصرها، يجعل هذه الترجمة لا تشتمل على أي تشابه مع الأصل".
ووصف المستشرق الفرنسي بلاشير هذه الترجمة بقوله: "لا تبدو الترجمة الطليطلية للقرآن بوجه من الوجوه ترجمة أمينة وكاملة للنص". ومع ذلك، شكلت هذه الترجمة النواة الأولى لباقي الترجمات الأوروبية الأخرى للقرآن الكريم، بل مارست عليها تأثيراً قويًّا إلى درجة الاقتباس منها، والسير على منهجها.
ثم توالت الترجمات القرآنية إلى اللغات الأوروبية بعد ذلك في الظهور؛ حيث ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية سنة (1647م) على يد أندري دي ريور، وقد كان لهذه الترجمة صدى كبير لفترة طويلة من الزمن، حيث أعيد طبعها مرات عدة، وتُرجمت إلى مختلف اللغات الأوروبية.
في نهاية القرن السابع عشر، وتحديداً سنة (1698م) قام المستشرق الإيطالي لودفيك مركي بترجمة القرآن الكريم من اللغة العربية مباشرة إلى اللاتينية، حيث أثبت النص العربي للقرآن مصحوباً بترجمة لاتينية وجيزة، وتعتبر هذه الترجمة عمدة كثير من الترجمات الحالية. وقد اعتبر هنري لامنز، هذه الترجمة أكثر الترجمات إنصافاً للقرآن الكريم، ومرجع كثير من المترجمين الأوروبيين، غير أنهم لا يشيرون إليها في معظم الأحيان، وقد قال: "إننا لا نملك ترجمة وحيدة للقرآن لا عيب فيها، وأكثرها إنصافاً هي الترجمة اللاتينية القديمة لـ مركي، والتي تستند إليها جميع الترجمات اللاحقة، من غير اعتراف في أكثر الأحيان".
وفي سنة (1734م) نشر المستشرق الإنجليزي جورج سال ترجمة مباشرة من العربية إلى الإنجليزية، زعم في مقدمتها أن القرآن إنما هو من اختراع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه، وأن ذلك أمر لا يقبل الجدل. ونشر الفرنسي سافاري ترجمة مباشرة إلى الفرنسية سنة (1751م) قال عنها دوارد مونتيه: "إنه رغم أن ترجمة سافاري طُبعت مرات عدة، وأنيقة جداً، لكن دقتها نسبية".
وفي سنة (1840م) ظهرت ترجمة كزيمرسكي التي تعتبر أفضل نسبياً مقارنة بترجمة سافاري رغم افتقادها لبعض الأمانة العلمية، وقصورها في فهم البلاغة العربية، يقول مونتيه عن هذه الترجمة: "لا يسعنا إلا الثناء عليها، فهي منتشرة كثيراً في الدول الناطقة بالفرنسية".
وفي سنة (1925م) ظهرت ترجمة إدوارد مونتيه التي امتازت بالضبط والدقة، والتي قال عنها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: "كنت طالعت في مجلة المنار مقالاً للأمير شكيب أرسلان عن ترجمة فرنسية حديثة للقرآن الكريم، وضعها الأستاذ إدوارد مونتيهـ وقد قال عنها: إنها أدق الترجمات التي ظهرت حتى الآن، وقد نقل عنها إلى العربية مقدمة هذه الترجمة، وهي في تاريخ القرآن، وتاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نشرت في مجلة (المنار) فاقتنيت هذه الترجمة، فوجدتها قد أوفت على الغاية في الدقة والعناية، وقد ذيلها المترجم بفهرس لمواد القرآن المفصل أتم تفصيل".
وفي سنة (1949م) نشر المستشرق الفرنسي ريجي بلاشير ترجمة للقرآن الكريم، اعتمد فيها التسلسل التاريخي لنزول السور، قال عنها الدكتور صبحي الصالح: "تظل ترجمة بلاشير للقرآن في نظرنا أدق الترجمات؛ للروح العلمية التي تسودها، لا يغض من قيمتها إلا الترتيب الزمني للسور القرآنية". وأهم ما يميز هذه الترجمة استعمال بلاشير أساليب مطبعية مناسبة، وإرفاق نص الترجمة ببعض التعليقات والبيانات، وكثيراً ما يورد للآية الواحدة ترجمتين، يبين في إحداهن المعنى الرمزي، وفي الثانية المعنى الإيحائي، وهذا ما جعلها أكثر الترجمات الفرنسية انتشاراً وطلباً. وقال المستشرق الفرنسي جاك بيرك عن هذه الترجمة: "إن ترجمة بلاشير لها مزاياها، فهو رجل من أفضل المستشرقين الأوربيين اطلاعاً وضلاعة في قواعد اللغة العربية وآدابها، ولكن من نواقصه أنه كان علمانيًّا، أي أنه لم يكن قادراً على تذوق المضمون الروحي للقرآن...وإن ترجمته للقرآن على الرغم من مزاياها، فإن لها نواقصها، ولكنها تبقى من أفضل الترجمات الفرنسية للقرآن".
ومع مرور الزمن لم تلق الترجمات الجديدة للقرآن الكريم في فرنسا الاهتمام نفسه، رغم ظهور ترجمات كثيرة إلى أن صدرت في العام (1990م) ترجمة جاك بيرك التي استغرق في إنجازها ثماني سنوات من العمل المتواصل، استعان فيها بالعديد من التفاسير المتقدمة كتفسير "جامع البيان في تفسير القرآن" للإمام الطبري، والمتأخرة كتفسير "محاسن التأويل" للشيخ جمال الدين القاسمي. وأهم ما يميز هذه الترجمة تلك المقدمة التي خصها بيرك لتحليل النص القرآني، ومزاياه، ومضامينه، والخصوصيات التي يتمتع بها. وعلى الرغم مما أحدثته هذه الترجمة من ضجة كبيرة في الأوساط العلمية الفرنسية، واعتبرت حينها حدثاً ثقافيًّا بارزاً، فإن صاحبها يرى أن عمله في هذه الترجمة لم يصل إلى مرحلة الكمال، وإنما سيكون موجَّهاً إلى المسلمين الذين لا يحسنون اللغة العربية، ويحسنون اللغة الفرنسية.
وفي سنة (1966م) ظهرت ترجمة المستشرق الألماني رودي بارت، والتي تعتبر أحسن ترجمة للقرآن الكريم باللغة الألمانية، بل باللغات الأوروبية عموماً، وقد حرص صاحبها على أن يكون عمله علميًّا، وأقرب ما يكون من الدقة والأمانة في نقل المعاني القرآنية من العربية إلى الألمانية، حتى إنه حينما تعترضه كلمة يُشكل عليه فهمها على الوجه المقصود، أو لا يطمئن إلى قدرته على تحديد معناها باللغة الألمانية، فإنه يثبتها بنصها العربي كما وردت في الآية الكريمة، ولكن بالحروف اللاتينية، ليفسح المجال أمام القارئ ليتوصل بنفسه إلى إعطائها المعنى الذي يراه ملائماً لسياق الكلام دون أن يفرض عليه وجهة نظره الشخصية.
هذه أهم الترجمات لمعاني القرآن إلى اللغات الأوروبية المختلفة، وهناك ترجمات أخرى كثيرة لا يفي المقام بذكرها.
هذا، وإن المطلع على الترجمات لمعاني القرآن إلى اللغات الأوروبية، يمكن أن يقف على ملاحظات عدة، نسجلها وفق التالي:
الملاحظة الأولى: كانت الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن الكريم، الشرارة الأولى التي فجرت كمًّا هائلاً من الترجمات بمختلف اللغات الأوروبية، حيث استمدت منها أصولها ونهجها، فظهرت الترجمة الإيطالية أولاً سنة (1547م) أي بعد أربع سنوات فقط من ظهور الترجمة اللاتينية الأولى إلى الوجود، وبعدها بتسع وستين سنة ظهرت الترجمة الألمانية سنة (1616م).
الملاحظة الثانية: أن المدارس الاستشراقية الكبرى التي كان لها شأن كبير في مجال الدراسات القرآنية، برزت بشكل واضح في مجال الترجمة القرآنية، كالمدرسة الألمانية، والفرنسية، والإنكليزية، والإيطالية.
الملاحظة الثالثة: اختفاء أسماء كثير من المستشرقين البارزين في مجال الدراسات الموضوعية للقرآن عن ترجمة القرآن الكريم إلى لغاتهم، كالمستشرق الألماني تيودور نولدكه، والألماني غوستاف فلوجل، وغيرهما، مع احتفاظ مستشرقين آخرين بمكانتهم وشهرتهم في ميدان ترجمة القرآن، مثل بلاشير في حين برزت أسماء أخرى جديدة، مثل الإيطالي جيوفاني بانزير، والألماني أولمان لودفيج، والهولندي جلازماخر، والفرنسي دي ريور، والإنجليزي جورج سال.
الملاحظة الرابعة: مشاركة بعض المسلمين في ترجمة القرآن إلى اللغات الأوروبية المختلفة، مثل حميد الله، الذي ترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية، وصدر الدين الذي ترجم القرآن إلى الألمانية، وأحمد علي أمير الذي ترجم القرآن إلى الإنكليزية.
الملاحظة الخامسة: هناك ترجمات أوروبية اعتمد فيها أصحابها الترتيب الزمني للسور القرآنية، مثل ترجمة الفرنسي بلاشير، والإنجليزي روديل سنة (1861م).
الملاحظة السادسة: عمد بعض المستشرقين في ترجماتهم للقرآن الكريم إلى وضع مقدمات منهجية لترجماتهم، وتفسير بعض الألفاظ القرآنية، كما فعل بلاشير، وكزيمر سكي، وبيرك.
الملاحظة السابعة: تتناثر بعض الترجمات الجزئية إلى جانب الترجمات الكاملة للقرآن، مثل ترجمة المستشرق السويدي سترستين، الذي ترجم فصولاً عدة من القرآن إلى الإسبانية، ونشرها في مجلة العالم الشرقي سنة (1911م) وترجمة المستشرق الدنماركي بول الذي نقل أجزاء عدة من القرآن إلى الدنماركية، أظهر فيها سعة اطلاعه على الإسلام.
الملاحظة الثامنة: صدور بعض الترجمات بأسماء مستعارة، مثل الترجمة الإسبانية التي صدرت الطبعة الأولى منها بقلم (OBB) وصدرت الطبعة الثانية بقلم (JBB) وأخيراً صدرت الطبعتان الثالثة والرابعة بقلم (JBBO).
الملاحظة التاسعة: أن الظاهرة الغالبة على الترجمات القرآنية، أن أصحابها كثيراً ما يصدِّرونها بالكلام عن تاريخ القرآن، ومصادره وموضوعاته وأحياناً بالكلام عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ترجمة بلاشير، وإدوارد مونتيه.
الملاحظة العاشرة: أن الترجمات الأوروبية للقرآن الكريم كانت من قبل مترجمين يحسنون اللغة التي ترجموا إليها أكثر من اللغة العربية، أو العكس، ولذلك كانت تلك الترجمات معرضة للخلل والنواقص الكثيرة.
الملاحظة الحادية عشرة: أن القرآن الكريم تُرْجِم إلى أكثر من مائة لغة أوروبية، تتوزع على الشكل التالي: (57) ترجمة إلى الإنكليزية، و(42) ترجمة إلى الألمانية، و(33) ترجمة إلى الفرنسية.
الملاحظة الثانية عشرة: إعادة نشر وطبع ترجمات معينة طبعات عدة، خصوصًا تلك التي سادتها الضغينة وكثر فيها التحريف.
والنتيجة - كما قال هنري لامينز: "إننا لا نملك ترجمة جيدة للقرآن لا عيب فيها" بسبب أن المترجمين للقرآن الكريم:
1ـ لم يحاولوا فهم القرآن قبل كل شيء من نصه، بحسب ما تقتضيه قواعد علم التفسير، بل إنهم انزلقوا دون تريث في البحث عن معاني الألفاظ.
2ـ لم يعنوا بمعاني الآيات ولا بمدلولات الألفاظ.
3ـ لم يكونوا من المتضلعين في علم اللغة العربية، ولا هم من المتمكنين من علوم البلاغة.
4ـ عدم اعتنائهم بأسباب النزول.
5ـ عدم اعتنائهم ببيان الأحكام الفقهية وغيرها من الأحكام الواردة في الآيات.
6ـ عدم تعرضهم لبعض الأدوات الضرورية التي تساعد على فهم الآيات القرآنية، كالنصوص الحديثية مثلاً.
وأخيراً، فإن ترجماتهم كانت غير منضبطة، ما أدى كثيراً إلى انغلاق المعنى على القارئ، إضافة إلى فقدانها لعنصر التأثير والجذب، يقول R.Aznaldez: "إن الترجمات الفرنسية كغيرها من الترجمات الأخرى للقرآن، مهما كانت نوعيتها وضبطها وقيمة أسلوبها، فإنها لا تؤثر في قلب غير المسلم، كما يؤثر القرآن وحده في قلب المسلمين".
* مادة المقال مستفادة من موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب (http://www.wata.cc) بتصرف.

 المقالات
المقالات









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات